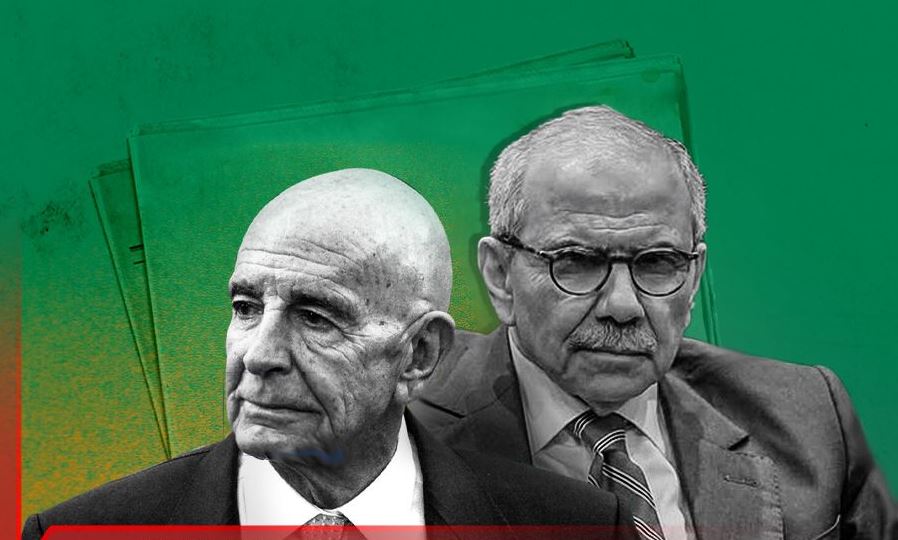أزمة الشرعية في النظام الرسمي العربي.. لبنان نموذجًا
د. بلال اللقيس
كاتب لبناني
لبنان نموذج لمن يأخذ بفرضية العقد الاجتماعي لتفسير الاجتماع السياسي، فإن العقد يبطل ما لم يكن بين أحرار. بالنسبة لـ “لوك” و “روسو”، السلطة طرف في العقد، فلا يكون العقد ناجزاً إذا لم تكن حرة. كيف بنا إذا كانت ممثلة أمينة لمصالح وأولويات الخارج!
الطامة أن سلطاتنا تفتقر لأيّ من مصادر الشرعية. فلا شرعية الكاريزما كزمن القوميات والعروبة مع عبد الناصر، ولا شرعية الإنجازات والنجاحات لحساب المجتمع والأمة وتحقيق انتصارات الشعوب، وحتى شرعية الحكم التقليدية القائمة على القبيلة والسلالة كما في الخليج مثلاً، فهي في تراجع.
ولا على شرعية دستورية يتقاسم فيها الشعب الثروة والسلطة مع الحاكم، فالعدالة مفقودة باحتكار الثروة عند أوليغاركية وجزر خاصة، أما المشاركة السياسية فشبه منعدمة أو شكلية في غالبية ساحقة من دولنا، بل إن السلطات دأبت على إبعاد المجتمع عن السياسة وتفكيك وتجزئة الفضاء العام. إذاً، فإن مصادر الشرعية للسلطة غير متوافرة في تجربتنا العربية الحاضرة، والعقد مفقود بغياب سلطات حرة وأحياناً شعب حر!
في بلد كلبنان، لا تقوم السلطة بمسؤولياتها، بل لا تقوم بأول مسؤولياتها، الحماية أو الحراسة كما كان يقول “هوبز”، ولديها من “الجرأة” أن تطلب من شعبها تحديد مهلة لإيقاف دفاعه عن نفسه وبلا أي ضمانة، علماً أن الشعب محتلة أرضه ويُمارس عليه العدوان يومياً من عدو أقر الدستور اللبناني بعداوته، ناهيك أنه عدو الأمة. المفارقة أن الحكومة تطالب شعبها بدلاً أن تتحمل مسؤولية أمام شعبها وتجيبه عن أسئلته، أو كأنها غير معنية بالإجابة عن سؤال السيادة الذي انعقدت شرعية استمرارها عليه. وللسائل أن يسأل؛ هل يصح العقد بينما الأرض محتلة أو مع حكومة ملتزمة أو منصاعة لأجندة خارجية أمريكية؟ وهل للمواطن اللبناني أن يقبل بها أم يتجاهلها ويتجاهل قراراتها السيادية الطابع؟ (فالمواطن الفرنسي الحقيقي والمُكرم هو ذاك الذي قاوم المحتل رافضاً قرارات حكومة فيشي الملتزمة بأجندة النازية وليس الخاضع لسلطة المحتل حتى لو كانت الأكثرية مع حكومة المحتل).
وفقاً للعقد الاجتماعي، فإنّ السلطة مقيدة بالدستور والمشروعية، وإذا ما أخلت بحرية المواطن وملكيته كما يذهب “جون لوك”، فيجب مواجهتها وإسقاطها، لكن كيف بها لو أخلت بحرية ومستقبل أكثر من نصف المجتمع كما هو حاصل اليوم في لبنان. لكن ما هو المخرج المعقول؟ فعندما تغيب عناصر الشرعية للسلطة والحكم، قد لا يوجد إلا الحوار وإنتاج لغة الحوار مدخلاً لإدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة والعالم ودولنا. نعم!! أن تنتج السلطة “الحوار” بمنهج علمي ومسؤول بما يمكن هذه المجتمعات القلقة من العبور الآمن نسبياً في زمن تغيير الخرائط.
فهذا قد يكون المرجع الوحيد الذي يمكن أن نوفره الآن، ولا يوجد بين أيدينا مسند آخر غيره ومرتكز، فمع الحوار وبه يمكن أن نؤسس لعبور بأقل كلفة كما نوهنا، وربما نستكشف رؤية اجتماعية جديدة لمجتمعاتنا. والحوار إذا لم يكن في اللحظات الحرجة فمتى يكون! لكنّ شرط نجاحنا في إنتاج لغة حوار هو أن لا تنظر الحكومة لنفسها كندّ للشعب كما هو حالنا في لبنان وعموم واقعنا العربي (تشعر أنك أمام ندّين متنافرين)، الحكومة هي ذلك التجسيد الخلاق لمسار الاجتماع الإنساني ودرجة متقدمة من العقلانية والتعبير عن الإرادة العامة، والأخيرة ليست حسبة عددية ولا مزاج شعبي في لحظة ضغط، بل هي فهم شامل لمعنى الإرادة الشعبية الذاتية واتجاهاتها وثقافتها واستثمار لتقاطعاتها بما يعزز كلمتها ومكانتها. إن أهل الحكم في بلادنا كخائف يترقب شعبه.
إنهم يفتقرون للقدرة على الإجابة كونهم لا يملكون الإحاطة ولا عقلانية المؤسسة ولا المعرفة أي لا يملكون السلطة، فالسلطة تتأتى عندما يشعر الشعب وتشعر الحكومة بالرضا أو السير لتحقيق الرضا المتقابل للتطلعات والتوقعات المتبادلة وصولاً للتطابق إن أمكن، لا أن ينظر الشعب إليها باعتبارها مستخدمة بدلاً أن تكون مؤتمنة ما يسقط مقوم الدولة الوطنية. هذا حال السلطة في لبنان، لا تعرف ما تريد في قضايا السيادة وفلسفة بناء الدولة، هي أقرب إلى شركة تضطلع ببعض الأمور المالية والإدارية والأمن الداخلي (وهي فاشلة أيضاً في ذلك)، وأما المجتمع فإننا أمام مجتمع لبناني يتميز عن كثير غيره من بلاد الشامات والخليج حيث المجتمعات مقيدة بالأصفاد النفسية وفاقدة القدرة على المبادرة السياسية. إن بنية المجتمع اللبناني وطبيعته جعلته حيوياً نشيطاً أفعل من كل حكوماته وغالباً أرشد، فلم تنجح كل محاولات تفكيك السياسة عن المجتمع كما في بقية الدول العربية ولا تفكيك الفضاء العام عن القضايا الكبرى فاستمر الصراع في جوهره على معنى السيادة والموقف من فلسطين والموقف من الغرب وإسرائيل والعروبة الحضارية والقيم والكرامة الوطنية.. إلخ. بقي جزء كبير من الشعب اللبناني يحمل قضايا أخلاقية وإنسانية وقضايا عدالة ولم ينصاع للحاكم وإرادة الخارج ولا للسطحية والتفاهة رغم كل التحديات التي مر بها في تاريخه. إن المقاومة بالنسبة لشريحة واسعة في لبنان والإقليم إرادة حقة ومصدر شرعية ومشروعية على السواء ومدخلاً لازماً لتثبيت التنوع ولا تحتاج شرعية من أحد.
وإذا ادعينا أنها لم تحقق الحماية ولم تردع، ففي ذلك تجنٍ ومغالطات. فمن يدعي أن المقاومة لم تحقق الحماية ولم تصن لبنان لعقود بالتعاون مع الجيش فهو يجافي الواقع. وهي اليوم لا زالت العنوان الأبرز لإبقاء لبنان ككيان واستمراره في ظل تحديات دولة الإرهاب وجماعات الإرهاب وسياسات أمريكا. ومن يدعي عدم القدرة بحجة أن التقنية تفوقت على الأيديولوجيا فهذه شبهة أخرى، لأن المقاومة ليست أيديولوجيا في مواجهة التقانة، بل هي مسألة متجذرة في الطبيعة الإنسانية والحق الطبيعي الذي يقبل به الإنساني السوي.
فالمسألة هي صراع حول معنى الحياة والحرية والأوطان والإرادة والكرامة ورفض التبعية في قبالة نموذج مضاد، وليس الصراع صراع التقانة بوجه الأيديولوجيا أو الأساطير كما ذهب البعض في تسطيحاته. كل ما نراه من شأن السلطة اليوم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وعند كل محك ومفصل وكما هو اليوم أن مشكلة لبنان ودولنا العربية تتجاوز تحولات موازين القوة وهي أبعد من القوانين بل والدستور “الشكلي” الذي غدا وجهة نظر إلى إشكالية سلطة المعايير التي تفتقد فيها الدولة لرؤية موحدة ومعنى متفق عليه لمعاني الشرف والكرامة والمصلحة الوطنية.
نختم، المنطق والعقل يقول أن الشعوب في طريقها لنيل تحررها لا تتوقف أمام “خضة” تصيبها أو تواجهها أو حتى أمام إخفاق وهزيمة فيما لو وقع، بل تستمر وتكمل، وإلا لم يعد للتاريخ معنى وقيمة ولا للتربية والاجتماع مكان. فالمعيارية ليست ترفاً ولا عيباً بل هي حاجة بشرية متأصلة وهي ضمانة لاستمرار التاريخ ونموه. فالذي يتخلى عن السيادة لعدوه يتخلى عما هو أدنى ويدخل مسار الهبوط في كل شيء وهو ما لا يجب أن يسمح به أي شريف في أوطاننا.